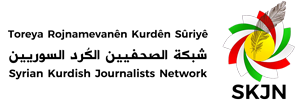مصطفى مصطفى
في الكثير من الأحيان، نصنف شعباً كاملاً حسب تصور استنتجناها من تعاملنا مع فردٍ واحد أو عدة أفراد ينتمون إلى ذاك الشعب، وأحياناً أخرى نقوم بتنميط تصرفات شخص أو سلوكه -إلى جانب عوامل عديدة أخرى- حسب جنسه أو عرقه أو ربما شخصيته، فكم مرة نعتنا الرجال بـ”عديمي المشاعر وميالين للعنف”، وكم مرة أطلقنا حكماً على أن المرأة “عاطفية” فلا تصلح للعمل في منصبٍ ما، أو حتى أنها لا تصلح لقيادة السيارة، مثلاً.
طبعاً، جميع تلك الأحكام والصفات والتسميات والتصنيفات هي نتيجة أفكار ومفاهيم معلبة ومقولبة ومتوارثة، رُسِّخت في أذهاننا، وحتى في اللاوعي، لنتحول إلى قطيع تابع نحو الانقياد التام تجاه تصورات شخصية وقناعات ذاتية واجتهادات ليست ثابتة ولا قطعية بالضرورة، بل صور نمطيّة… ونمطيّة فقط.
لا أسس علميّة لبعض المفاهيم المتداولة
دليار حسين (27 عاماً)، وهي لاعبة ومدربة لفن التايكوندو (نوع من أنواع الفن القتالي الكوري التقليدي)، من مدينة الحسكة، في شمال شرقي سوريا، بدأت المشاركة ضمن صفوف اللاعبين واللاعبات منذ عام 2010 في “مدرسة نمور التايكوندو” بمدينتها، لتنال بعدها عدة ميداليات في بطولات محلية وعالمية. لكن رحلة دليار وخيارها كان حافلاً بالصعوبات؛ وذلك “بسبب تنميط المجتمع للفنون القتالية وتصنيفها ضمن الأدوار الجندرية والفنون الذكورية، وأن تلك الفنون خاصة بالرجال ولا تناسب المرأة”.
تقول دليار: “الصورة النمطيّة للمرأة في مجتمعاتنا مبنية على مفاهيم خاطئة، ولا أسس علمية تثبت أن لعبة التايكوندو لا تصلح للنساء، والدليل أنني حافظتُ على كياني كامرأة ونلت الدرجات العلية في التايكوندو، اللعبة التي يصنفها المجتمع بأنها “ذكوريّة”؛ لأكون الأولى على مستوى سوريا والمشاركة في عدة بطولات محلية ودولية، والحصول على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، إلى جانب شهادة دولية في التايكوندو من كوريا”.
من الصور النمطيّة الرائجة ضمن مجتمعاتنا؛ أن كل موهبة أو فن يحتوي على أمور متعلقة بالدفاع عن النفس والقتال تنحصر ضمن الاهتمامات الذكورية، وأنها تضر بـ”معايير الأنوثة” لدى المرأة، كـ فن التايكوندو. لكن “في الحقيقة أن هذا الفن (التايكوندو) يستند في أساسه على المهارات العقلية في استخدام القوة البدنية، فهو تدريب للاستخدام المناسب والصحيح للعقل واليد والقدم في مسائل الدفاع عن النفس، وبناء الشخصية القوية للمرأة. وبالتالي، هناك أمور وجوانب أهم من المفهوم المتداول، وهذا ما لا يتقبله المجتمع؛ لأنه دائماً يرى المرأة الحلقة الأضعف، وأن شخصيتها مترددة ولا تمتلك زمام المبادرة” حسب تعبير دليار.
“المسألة ليست متعلقة بالبنية البيولوجية”
إن المثابرة والإرادة القوية –أحياناً- تكفلان نتائج إيجابية وتحقيق الأهداف المرجوة، ربما من الصعب مواجهة مجتمعاً برمته، لكن تحقيق النجاحات وإثبات الذات من شأنهما تغيير بعض المفاهيم في المجتمع وكسر العديد من الصور النمطيّة للمرأة، وهذا ما حصل –تماماً- مع دليار، بعد نيلها الكثير من الجوائز والميداليات ضمن مجالها، حيث تقول: “نتيجة لمشاركاتي في العديدة من البطولات العالمية والمحلية وتحقيقي لمستويات عالية، استطعتُ كسر العديد من الحواجز المجتمعية والصور النمطيّة للمرأة، واجتزتُ المصاعب، حيث أن نسبة المرأة المشاركة في فن التايكوندو بدأ يزداد يوماً بعد يوم، ومن دواعي سروري أن أرى اليوم في كل بيت من بيوت مدينتي –تقريباً- امرأة تشارك أو تحاول المشاركة في فن قتالي يُصنف -حسب العديد- ضمن الفنون الذكوريّة، فالمسألة ليست متعلقة بقدرات المرأة وبنيتها البيولوجية، إنما بمدى تقبل المجتمع ودعمه لإرادة المرأة في سبيل تحقيق طموحاتها وأهدافها، مثلها مثل الرجل”.
“أبو علي… محمد خورتو”
لا شك أن الصورة النمطيّة باتت شبحاً يلاحق المرأة أينما سارت أو اتجهت، فطريقة وأسلوب المرأة في اللبس والكلام والعمل والعلاقات الاجتماعية وحتى لغة جسدها أصبحت أفكار وقواعد معلبة ومعدة مسبقاً تحت ذريعة “الأنوثة”، حيث هناك أشخاص يعتقدون “أن بعض النساء تنازلن عن أنوثتهن بحجة التطور والجري وراء نمط الحياة السريع، ولاسيما في العصر الرقمي”. لكن كلما حاولت المرأة كسر تلك الصورة، وأن مفهوم الأنوثة ليس متعلقاً باللون الزهري والكعب العالي والقوام الرشيق والمنحوت ووضع المكياج، اصطدمت بجدار العادات والتقاليد و”المعايير” المجتمعية وانطباعات متوارثة، وأن “أنتِ مرى، عيب!” لتصبح عملية التنميط، عملية ذهنية يتداخل فيها الوعي واللاوعي.
ليلى حسو (22 عاماً) من مدينة القامشلي، في شمال شرقي سوريا، تعيش أزمة مواقف وصور نمطيّة للمرأة كُرّست في مجتمعها، حيث تتعرض لها أينما كانت أو اتجهت، وذلك نتيجة سلوكها ولغة جسدها اللتان تصفهما ليلى بـ”طبيعية جداً”، وكذلك اختياراتها الشخصية. ليلى لا تلعب فنون قتالية، وإنما “شخصيتها قوية، وتحب أن تلبس ملابس السبور، والتدخين، وتؤدي المسؤوليات الشاقة التي تتطلب جهد وقوة بدنية وتُصنّف كمسؤوليات ذكوريّة، مثل حمل جرة الغاز، وتشغيل مولدة الكهرباء “البيتر”، وتعبئة وقود السيارة في منزلها” كما تبيّن نفسها، مما استدعى جزءاً من محيطها لأنْ يلقبوها بـ”أبو علي”؛ وهذا تعبيرٌ رائجٌ في مجتمعاتنا عن المرأة التي تتسم بشخصية قوية، وتصرفات ولغة جسد تُعتبران “ذكورية”.
بثقة تامة وابتسامة تخفي في طياتها التفاؤل، تقول ليلى: “أتصرف حسب طبيعتي التي خُلِقتُ عليها، لا أتصنع ولا أتصرف كمتمردة، فهذه أنا ليلى! أحب مساعدة والدي في الكثير من الأمور المنزلية؛ لأنني أشعر في نفسي بأنني “ست ورجل البيت”، فلا مشكلة لدي في حمل جرة الغاز وتشغيل المولدة في البيت ما دمت أستطيع فعل ذلك دون أن أغير شيء في كياني! لا أنكر أن لقب “أبو علي” مزعج جداً بالنسبة لي، أحياناً أحاول أن أغير أسلوب مشيتي ولغة جسدي الطبيعيتان لأحمِ نفسي من تلك التعليقات، لكن هذا هو مجتمعنا لا يريد أن يرى المرأة ذات الشخصية القوية، ويصرف نظره عن الجانب القوي الذي تتمتع بها المرأة مثلها مثل الرجل، وذلك بذريعة أن المرأة يجب أن تكون ناعمة وخجولة و”القط ياكل عشاها”، تحت يافطة المحافظة على الأنوثة”.
إلى جانب لقب “أبو علي”، هناك عبارات أخرى ترافق مواقف التنمر التي تعيشها ليلى أحياناً في حياتها، كعبارة “محمد خورتو” (خورتو كلمة كردية تعني الشاب)، وكذلك “الله بالغلط خلقك أنثى”، خاصة عندما تساعد والدها في بعض الأمور المنزلية، فتقول: “كثيراً عندما أساعد والدي في تعبئة سيارته بالوقود في المنزل، أو في تشغيل المولدة الكهربائية أسمع من يقول: ها محمد خورتو، كان المفروض هلأ بدل المازوت تحطي أظافر ومناكير!”.
“كلنا نحب الاختلاف… لكننا لا نتقبله”
تؤكد ليلى أن تصرفاتها وسلوكها ولغة جسدها “ليست خيارات شخصية ولا أحد يستطيع أن يفرض شخصية أخرى على نفسه، فما يميزنا هو الاختلاف ويجب أن نحترم هذا الاختلاف لأنه لا يضرّ بأحد، وهذا لا يستدعي التوقف عنده ولا يثير الشفقة كما ألاحظها أحياناً في نظرات بعض الناس، لأن هناك الكثير من النساء يتمنين أن تصبح شخصيتهن مثل شخصيتي، ولكن خوفاً من كلام المجتمع لا يفصحن عن ذلك، لذا فالفرق بيننا هنا، أنني أعيش حسب طبيعتي، وهن يتصنعن من أجل إرضاء المجتمع، وإرضاء الناس غاية لا تُدرك!”.
لو بحثنا ضمن مسائل المساواة بين الرجل والمرأة فيما يخص فرص العمل من حيث الحقوق والواجبات والميّزات؛ فسنرى تفاوتاً كبيراً في الكثير من الدول، وسترجح كفة الميزان للرجل، لكن التركيز على الشكل وخلق صور نمطيّة “مثالية” للمرأة في بعض المؤسسات أثْقَلَ من حمل المرأة أكثر، وبات كما يقال “طلع من حفرة ووقع في دحدورة”، حيث تقول ليلى: “في إحدى المرات قدّمتُ على شاغرٍ في إحدى المؤسسات، وبالرغم من أن الخبرات المطلوبة كانت موجودة لدي، إلّا أن سبب الرفض كان صادماً، حيث قالوا لي بصريح العبارة إن شخصيتي ولبسي وحتى مشيتي ذكورية وأشبه الرجال! انتابني في تلك اللحظة شعور سيء وتعيس!”.
لكن رغم كل ذلك، ليلى لم تغيّر شيئاً في شخصيتها واختياراتها، فهي تؤكد أن “التصالح مع النفس هو الطريق الوحيد لاجتياز المرأة ما تواجهه في مجتمعنا، خاصة عندما يكون هناك دعم عائلي، ولا بد أن يتقبل المجتمع اختلافنا حتى وأن كان على مستوى المحيط الضيّق، لأن إصراري وتمسكي بشخصيتي وطبيعتي كانا السبب في أن يتقرب الكثير مني؛ فقط من أجل معرفة جوهري، وهذا أسعدني كثيراً. ربما كلنا نحب الاختلاف، لكننا لا نتقبله”.
في كتابها “الجنس الآخر”، تقول الفيلسوفة الفرنسية سيمون دوبوفوار، والمعروفة بأفكارها النسوية: “الإنسان لا يولد امرأة، بل يصبح ذلك لاحقاً”.
بكل تأكيد، “بوافر” لا تقصد هنا كيان المرأة البيولوجي، إنما تشير إلى كيانها العاطفي والنفسي والاجتماعي، فما تريد قوله هو إن المرأة تخضع لعملية “تنميط”، وتتعرض لقولبة جسدية وذهنية ونفسية؛ لتهيئتها للدور الاجتماعي والهوية التي يعدها لها المجتمع، مما يترتب على ذلك نتائج سلبية تحد من تمكين المرأة على تنمية قدراتها الشخصية، واتخاذ خيارات بشأن حياتها ومواصلتها. لذا، فإن التعميم المبالغ فيه لصفات وطبائع واختلافات مجموعة معيّنة بناءً على أسس جندرية، تخلق أحكاماً مسبقة وقدرات وصفات تُقرن بنوع اجتماعي بعينه، بينما –في الواقع- يمكن لتلك القدرات والصفات أن تتواجد عند كل شخص، على اختلاف نوعهم الاجتماعي.
من الممكن أن تصل عواقب تعميم الصور النمطيّة إلى مراحل خطرة، ومع مرور الزمن، قد تتحول الصور النمطيّة هذه إلى قناعات وأحكام تُبنى عليها سياسات ومواقف، وتكون أساسًا في التعامل بين الأطراف المختلفة، مما ينتج عنها سوء في التقديرات وتسرّع في المواقف.
مصطفى مصطفى ـ كاتب صحفي