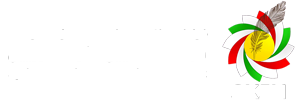شفان إبراهيم
يكثر الحديث عن الأدوار التي تقوم بها المرأة الكردية في سوريا، لكنها تبقى دون المستوى المأمول بل على مستوى السطح، لطالما بقي التمثيل الجندري غائباً عن صناعة القرار الإعلامي، فعلى سبيل المثال لنبدأ من السؤال التالي: هل تساهم المرأة الكردية في صناعة المشهد الإعلامي عبر الإعلام الكردي سواء الرسمي التابع للإدارة الذاتية، أو المجلس الكردي، أو الأحزاب السياسية المختلفة؟ وربما لا يحتاج السؤال للكثير من البحث أو الجهد لمعرفة أن مشاركة الصحفيات الكرديات لا يتجاوز الأداء الوظيفي في أغلب الأحيان، أو توفير السيولة الخطابية لإعداد البرامج، لكنها شبه مغيبة بالكامل عن رسم السياسات الإعلامية.
وهو ما يعني غياب مقاربة النوع الاجتماعي في الإعلام، وأيضاً ما يعني غياب التنمية؛ لإن إزالة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين الصحفيين/ات شرط أساسي ومسبق لتحقيق التنمية والتطور الإعلامي المنشود.
نقص حاد في أدوار الجندرة إعلامياً وسياسياً
بمعنى أن المجتمع الكردي بحاجة للنظرة الإعلامية المتكاملة في محاولة لفهم أدوار الجندرة في الإعلام مع ضرورة تحديد الأدوار والمسؤوليات الممنوحة لكل منهما، وهو ما يؤدي إلى إزالة التفاوتات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بين الإعلاميين والإعلاميات، وتحقيق التوازن بينهما كممهد للمساواة الكاملة، وهكذا فإن مقاربة النوع الاجتماعي تهدف لردم الفجوات بين الجنسين في صناعة القرار الإعلامي لتحقيق المساواة بينهم بالمفهوم الاستراتيجي.
لا أعتقد إننا نبالغ بالقول إن الصحافيات والسياسيات الكرديات من بين النساء الأكثر قهراً في الوسط النسوي الكردي السوري، خاصة وأنه لا يمكن الحديث عن واقع الإعلاميات بمعزل عن حال النساء بشكل عام، فنسبة تمثيل النساء في قوة العمل في المؤسسات الإعلامية الكردية الحزبية منها أو الخاصة أو الحكومية وإن كانت تشهد أعداد ليست بالقليلة في مجال الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، لكنها بمجملها لا تخرج عن دائرة تقديم نشرات الأخبار أو المراسلة، وفي حالات قليلة جدا نجد الصحافية صاحبة برنامج حواري سياسي -اقتصادي -ديني رصين، لكنها بالمجمل خارج دائرة صناعة القرار الإعلامي أو رسم الاستراتيجيات الإعلامية للإعلام الحزبي أو الحكومي بشكل خاص.
ولا عجب حينها لغياب مشاركة المرأة الكردية في صناعة أو رسم القرار السياسي، فغالبية مسؤولي مكاتب الإعلام في التنظيمات السياسية إما لا يحملون شهادات صحافية، أو ليس لهم خبرة أو ممارسة للمهنة، مع ذلك يتحكمون بمجموعة من ذوي الخبرات الإعلامية والصحافية.
صحيح أننا لا نملك إحصائية دقيقة لا لعدد خريجات الصحافة، ولا لمن مارس المهنة كمواطنة صحفية، لكن الإحصائية الأكثر فقداً هي نسبة البطالة بين صفوف خريجي الإعلام أو من مارست المهنة وفقدت عملها بسبب توقف التمويل.
ولا مؤشرات لتغيير الصورة النمطية عن عمل المرأة في الصحافة خارج الاستفادة من وجود العنصر النسائي للتدليل على حجم انخراط المرأة في العمل، وهو ما يعني أن الذكورية تطغى على الإعلام كحال السياسة والأحزاب وغيرها من الميادين، وتالياً فإن مستقبلاً سيئاً ينتظر هذه المنطقة.
هل يعقل ألا توجد صحافية تمتلك مؤهلات لإدارة مؤسسة إعلامية رسمية/حكومية أو حزبية، أو أن تستلم قيادية حزبية مكتب الإعلام المركزي وتديره بعقلية “دور الإعلام في صناعة الرأي العام الإيجابي”. ولو نظرنا لواقع التنظيمات السياسية والإدارية الموجودة في المنطقة الكردية، فإن الغالبية الساحقة لمكاتب الإعلام المركزي، الوسائل الإعلامية المختلفة لاتُقاد من قبل صحفيات، بل لا شراكة حقيقية للصحافيات الموجودات فيها، وفقاً لحديث غالبية الإعلاميات اللواتي التقينا بهم.
زيادة في الكم وحصار للكيف والنوع
لنتفق أن أعداد الصحفيات وعملهن في المؤسسات الرسمية والحزبية هي مؤشرات تقريبية، ولكنها ليست مرآة تشرح حقيقة واقع النساء الإعلاميات أو السياسيات، فزيادة عدد النساء المنخرطات في الفضاء السياسي العام من كاتبات، شاعرات، ناشطات، صحافيات وحزبيات لا يعكس حقيقة واقعهن، بل أن الانخراط يبقى على مستوى السطح دون العمق والمضمون، وتبقى المشاركة النسائية منحصرة على مستويات محددة فحسب.
لذا لا فصل للواقع النسائي في المجال الإعلامي عن السياسي، فهذه العقلية السياسية الإقصائية للعنصر النسائي عن صناعة القرار، هو عينه الذي أبعدها عن رسم السياسات الإعلامية، فنسبة وصول المرأة الى المراكز القيادية في الأحزاب لا تتجاوز الـ2% في أحسن الأحوال أو تواجد مكثف للعنصر النسائي، لكنها فاقدة للفاعلية الحركية ومبعدة عن دوائر القرار، وغالباً ما يتم إبعادهم عن أي تمثيل ضمن أطر سياسية أو ائتلافات حزبية وتنحصر المناصب السيادية بعدد ونساء محددات وفقاً لرتم عائلي أو انتماء سياسي محدد، فيتم مداورة تلك المناصب بينهم بشكل دوري.
خاصة وأن التمثيل الجندري في بعض جوانبه تعبير سياسي عن حجم الوعي المتغلغل في الوسطين السياسي والإعلامي، فالاكتفاء بالجملة الأكثر استهلاكا في الوسط الكردي ربما أكثر من أي دولة أخرى “المرأة نصف المجتمع” لا تعني أنها وصلت إلى حقوقها، لطالما لا يُفسح لها المجال للقيام بالأدوار التي تطالب بها.
خاصة وأن تقسيم العمل وفقاً للنوع الاجتماعي يفتح أمام المرأة افاق التعبير عن السلوكيات والمواقف من أغلب القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، في حين أن الأحزاب والمجتمعات التي تضع سدوداً وتحديداً صارماً لتلك الأدوار، تكون حرية الصحافة مهددة لدرجة كبيرة، بل أن تعميم النمطيات القائمة على دونية المراتب المخصصة للصحافيات والسياسيات تجد طريقها للانتشار والتطبيق؛ لإن الاعلام ومؤسساته والأحزاب السياسية وهياكلها هي أبرز الأدوات لترسيخ نمطية معينة، فيكون المجتمع الأنثوي بشقيه الإعلامي والسياسي أمام ترسيخ صورة محددة تنتج ثقافة تمييز أو دعم وتضمين على النوع الاجتماعي، وبالتالي تُخلق مساحة خصبة لإعادة إنتاج المكانة العليا أو المتدنية للمرأة، والاحتفاء بها ضمن دوائر ضيقة لا يُفسح أمامها أي مجال للعمل والقيادة والشراكة.
إعلام خاص فقد بريقه
شهدت المنطقة طفرة في عدد الصحافيات والإعلاميات العاملات في قطاع الإعلام الخاص، ومنهن من أثبتن جدارتهن في إدارة المؤسسة الصحافية نفسها، حيث يُثبت متابعة الواقع الإعلامي، أن الصحافيات الأكثر تأثيراً في صناعة القرار والبرامج الحساسة والمهمة والسياسات العامة للإعلام أو نيلاً لعضوية رئاسة الجهة الإعلامية، انحصر في الإعلام الخاص من مواقع الكترونية، محطات إذاعة… إلخ، لكنها هي الأخرى لا تزال تحتاج للمزيد من الدعم وتغيير فكرة أن صاحب القرار الإعلامي يُفضل أن يكون محصور بيد صحافي/سياسي/ناشط فحسب أكثر من الصحافية، مقارنة بحيازة العدد الضئيل من الصحافيات لصناعة القرار في تلك المؤسسات.
ويُمكن فرز عمل الصحافيات في الفضاء الإعلامي الخاص إلى ثلاث أقسام، الأول: مشاركة دون فاعلية؛ نتيجة غياب الإمكانيات والمؤهلات. الثانية: ذوات كفاءة عالية وتمكن من إثبات أنفسهم وصناعة محتوى إعلامي وسياساتي مميز. الثالثة: تبوأ صحافيات صدارة المشهد الإعلامي للمؤسسة الخاصة، تنفيذاً لشروط الممول والجهة المانحة.
بالعموم الإعلام الخاص يفقد بريقه نتيجة عدّم “التحديث” في الآليات والكوادر، والجو الإعلامي العام يشهد ضغوطات وطفرة في العدد دون فاعلية، لكن تبقى بذرة ولادة صحافة وإعلام بكفاءة ومهنية ومراعاة الجندرة والنوع الاجتماعي موجودة وقابلة للتطوير والاشتغال عليها.
شفان ابراهيم : كاتب صحفي وباحث مقيم في القامشلي
الصورة تعبيرية من النت
الآراء المنشورة في المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع